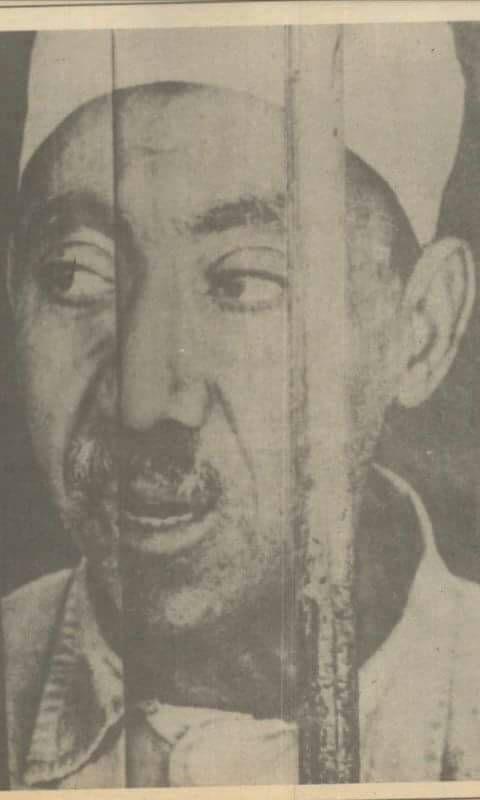الحكم بالإسلام في ضوء فقه الاستطاعة

ملاحظة استباقية: تتصل هذه المقالة بمقالة “قتلَ الله من قتل بجهله أهلَ الشام” التي سبقت قبل أيام، وكان ينبغي أن أنشرها بعدها على الفور لولا أنني شُغلت عنها بأشغال. وقد كتبتها في محاولة للتقريب بين فريقين يجتمعان في الغاية (وهي تحقيق حاكمية الله في الأرض) ويختلفان في تقدير الظروف والأحوال واختيار الوسائل الموصلة إلى الغاية، فكاد هذا الاختلاف يتحول إلى خصومة تفرّق الإخْوةَ وتشتت جهودَ العاملين للإسلام. فإذا نجحتُ في التقريب بين الفريقين فحسبي، أما إقناع كل واحد فلا أطمع فيه فإنه محال. علماً بأن ما كتبته هنا هو اجتهاد يحتمل الخطأ والصواب، فإن أصبت فإنما صوابي بتوفيق الله وفضله، وإن أخطأت فيكفيني أني اجتهدت بالبحث عن الصواب.
1- إن مما يعلمه كل مسلم (أو ينبغي أن يعلمه) أن الإسلام دين ودولة، وأنه منظومة متكاملة تشمل نواحي الاعتقاد والعبادة والأخلاق والسياسة والاقتصاد والعلاقات الإنسانية والاجتماعية، فمَن آمن بالإسلام آمن بصلاحيته للتطبيق في كل نواحي الحياة، ومن آمن بالله آمن بأنه مالك الوجود وصاحب الحكم فيه. من هنا قرر الأصوليون أن “الحاكم هو الله”، ليس بمعنى الحكم السياسي الذي يتبادر إلى الأذهان على سبيل الحصر، وإنما بمعنى الهيمنة على كل نواحي الحياة.
وقد شهد العصر الأخير اضطراباً في فهم هذا المبدأ العظيم (الذي سمّاه المودودي “الحاكمية” وتبعه في ذلك سيد قطب، رحم الله الاثنين) فحُصر في الفقه السياسي دون سائر أبواب الفقه، وفهمَت فئةٌ من المسلمين أن المقصود به هو “حكم الدولة” فقط ولم يفهموا أنه حكم الفرد والأسرة والمجتمع أيضاً، فتقاعسوا عن تحكيم الإسلام (أو الدعوة إلى تحكيمه) في الحياة الفردية والأسرية والاجتماعية، ونشطوا في المطالبة بتحكيمه في الحياة السياسية، واعتبروا أن تحقيقه بهذه الصورة هو أصل الأصول، ولم يبالوا بأن يتوصلوا إليه باستعمال القوة وبتحميل الأمة جهداً ثقيلاً. ثم جَنَوا عليه جناية أخرى حين جرّدوه من المرونة التي تتصف بها جميع التكاليف الشرعية، والتي منحت الإسلامَ القابليةَ للحياة والحكم في كل الأزمنة والأمكنة والأحوال.
وفي ذلك كله تضييقٌ لمعنى حاكمية الله وتخصيصٌ غيرُ مبرَّر لقاعدة “الحاكم هو الله”. والصواب أنها تتسع حتى تشمل مسائلَ التكليف كلها، الفردية والجماعية، والحق أن تُطبَّق على تلك المسائل جميعاً القوانينُ الأصولية ذاتها، ومنها قوانين فقه الاستطاعة التي عرضتها في المقالة السابقة.
2- ناقشت في المقالة السابقة “فقه الاستطاعة”، وعرضت النصوصَ التي تؤصّل له والقواعدَ الشرعية التي تقعّده، وأهمها قولهم “لا تكليف مع العجز”. وهي قاعدة جليلة نستفيد منها أن التكاليف الشرعية ليست “مطلقة” بل إنها “نسبية”، فهي تتفاوت من شخص إلى آخر لأنها تأخذ بعين الاعتبار حالةَ المكلَّف وقدرتَه على تنفيذ التكليف. إنها صحيحة دائماً من الناحية النظرية، أما من الناحية العملية (التي يُبنَى عليها الحسابُ في الآخرة) فإنها رهنٌ بالقدرة على تنفيذها، وفي هذا المعنى المهم يقول الإمام الشاطبي في “الموافقات”: “شرط التكليف الاستطاعةُ والقدرةُ، فما لا قدرةَ للمكلَّف عليه لا يصحّ التكليف به شرعاً وإن جاز عقلاً”.
وهذه القاعدة العظيمة لها آلية محددة تعمل بموجبها، فهي ترفع العبء عن المكلَّف ولكنها لا تُسقط العمل بالكلّية، فماذا تفعل إذن؟ إنها تعمل وفق القاعدة الأصولية المكمّلة: “المشقة تجلب التيسير”، فلو شَقّ التكليف على المكلَّف لم يرتفع أصلُ التكليف، وإنما هو ينتقل إلى حكم أيسر. فإذا لفّ يدَه بجبيرة لم يكلفه الشرعُ عناء فكّها وغسل يده عند كل وضوء وانتقل الحكم إلى التيسير بالمسح عليها، وإذا شَقّ عليه الوقوفُ للصلاة لمرض عارض أو عجز دائم انتقل الحكم إلى التيسير فصلى قاعداً، وإذا شق عليه الصيام انتقل إلى الإطعام، ومثل ذلك في الفقه أكثر من أن يُحصى.
هاتان القاعدتان تتكاملان لرفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولجعل الإسلام ديناً صالحاً لكل الأزمنة على الإطلاق بعدما وضع عن أتباعه ما كان على سابقيهم من آصار وأثقال وأغلال: {ويضع عنهم إصرَهم والأغلالَ التي كانت عليهم}، {ربَّنا ولا تَحْمِل علينا إصْراً كما حملته على الذين من قبلنا}.
3- ذهب الجمهور إلى أن القدرة من شرائط أصل وجوب ركن الحج، وخالفهم الأحناف فقالوا إنها شرط وجوب أداء الحج لا شرط وجوب الحج نفسه. والمحصّلة واحدة وإن اختلف اللفظ، فإن العاجز عن الحج لا يطالَب به، أو أن فريضة الحج لا تتعيّن على غير المستطيع. والحج ركن ركين من أركان الدين يُقاس عليه من التكاليف ما عداه، فلئن اهتم فقهاؤنا بتأصيل فقه الاستطاعة في باب الحج لأنه ركن مَبني عليها وعلى توفر أدواتها كما هو معلوم، فإن الناظر في الأدلة الجامعة في الأصلين، الكتاب والسنّة، يجد أن العملَ بالاستطاعة قاعدةٌ كلية مطّردة ثابتة بعموم النصوص، وهي من قواعد الشريعة الكبرى التي لا ينكرها ويردّ العملَ بها في موضعها إلا ذو جناية على الشرع ونكاية بالمسلمين.
هذا الأصل الجامع لا يهيمن على فقه العبادات فحسب بل على سائر أبواب الفقه، وتدخل فيه مسائل السياسة الشرعية من باب أَولى، لأنها قائمة أصلاً على مراعاة مصالح العباد. إن تنفيذ التكاليف الشرعية كلها مَنوط بالاستطاعة، يستوي في ذلك الحجُّ والقيامُ في الصلاة مع الجهادِ وإقامة دولة الإسلام، وكلُّ عمل يتجاوز الوسع وكلُّ واجب تنشأ عنه مفسدة كبرى فإنه يصبح مستحيلاً معنوياً ولو كان ممكناً حسياً. ومن هنا قال ابن القيم رحمه الله إن المفتي لا يستقيم له أمر الفتوى إلا بالجمع بين فهمَين وفقهَين: فهم الواقع والفقه فيه، وفهم الواجب في الواقع، أي الفقه بحكم الله ورسوله فيه.
4- صحيحٌ أنّ إقامة الدولة الإسلامية فريضة واجبة على الأمة، ولكنْ إذا عجز المسلمون عن إقامتها في قطر من الأقطار فإن هذا الواجب يسقط عنهم إلى حين القدرة عليه، لأن عدم الاستطاعة يُسقط الوجوب كما رأينا آنفاً. ولكن هل معنى هذا أن يتخلى المسلمون عن الدين إذا عجزوا عن إقامة دولة إسلامية؟ لو فعلوا وفرّطوا بدينهم فسوف يحاسبهم الله. هنا تأتي القاعدة الثانية التي أشرت إليها قبل قليل: الانتقال من التكليف الشاق العسير إلى التكليف الممكن اليسير.
إنهم قد يعجزون عن تحكيم الإسلام في الحياة السياسية، ولكنهم يستطيعون (بتفاوت وكل بحسب مقدرته) أن يَدْعوا إلى الإسلام وإلى تحكيمه في سائر نواحي الحياة، فيحكّموه في سلوكهم الشخصي وعبادتهم الفردية وفي حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، ويكون العمل بالدعوة والإصلاح هو البديل الممكن عن العمل غير الممكن بتغيير الواقع السياسي.
5- نجحت حركات إسلامية إصلاحية معاصرة في فهم الواقع الصعب الذي تعيشه الأمة واستطاعت أن تحقق -خلال القرن المنصرم- إنجازات كبرى على طريق الإحياء والتمكين، فإنها لما عجزت عن تحقيق الحلم الأكبر، وهو حكم الأمة بشرع الله، انتقلت إلى الممكن المتاح، وهو الدعوة إلى الله، فحفظ الله بها الدين وأصلح العباد، وكان من ثمرة جهدها واجتهادها أن استعادت الأمة هويتها المفقودة، وأقبلت على التدين والالتزام بأحكام الإسلام، وتخلصت من أكوام من الموروثات الدينية الخاطئة، وامتلكت الوعيَ بالدين والوعيَ بالواقع، فبدأت تسعى جاهدة لاسترجاع موقعها الرائد بين أمم الأرض.
واستطاعت بعض الحركات الإسلامية أن تستثمر الأدوات السياسية المتاحة لتحقيق مصلحة الإسلام والمسلمين، فوصلت إلى الحكم في بعض البلدان وحكمت بالشريعة على قدر الوسع، ولكنها ابتُليت بقوم من هواة التشديد والتكلف، “ظاهريين” في الفقه السياسي، ما يزالون يلاحقونها ويحاربونها أشد الحرب لأنها لم تَستوفِ شروط الحكم الإسلامي الرشيد كما يقولون، فوصفوها بالعَلمانية ورموها بالكفر والردّة لأنها حكمت بقوانين “وضعية” ولم تطبق الأحكام الشرعية جملة واحدة، ولأنها أنشأت أنظمة برلمانية انتخابية (شركية كما يزعمون)، ولم يدركوا أن هذا هو قدر الوسع في حالة الضعف والوهن التي تعيشها الأمة، ولم يعلموا أن الوصول إلى الدولة الإسلامية النموذجية يحتاج إلى حكمة وتدرج ونَفَس طويل.
فكان من ثمرات تكلّفهم وتعسفهم أن وصفوا بالعلمانية حكومات العدالة في تركيا والإخوان في مصر وحماس في فلسطين، وفيما اكتفى بعضهم بالحكم العام على الجماعات والأحزاب فإن آخرين ذهبوا شوطاً أبعد، فحكموا بالكفر والردة على مرسي وهنية وأردوغان! بل إن أحدهم لم يُبالِ أن يحكم على مجاهدي الشام في الجبهة الإسلامية بالكفر والفسوق كما رأينا من وقت قريب. هذا مع أن تلك المشروعات صنعت للأمة في بضع سنين ما عجز أصحاب المشروعات الخيالية عن صنع معشاره في عشرات السنين.
6- يقول سفيان الثوري: “إنما العلم رخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل واحد”. وفي تاريخ الإسلام للذهبي أن عبد الملك قال لأبيه عمر بن عبد العزيز يوماً: ما يمنعك أن تَمضي للذي تريد؟ والذي نفسي بيده ما أبالي لو غَلَت بي وبك القدور. فقال: يا بُنَي، إن آباءك وأجدادك قد دَعّوا الناس عن الحق (أي دفعوهم وأبعدوهم عنه)، فانتهت الأمور إليّ وقد أقبل شَرّها وأدبر خيرُها، ولو بادهتُ الناس (فاجأتهم) بالذي تقول لم آمَن أن ينكروه، فإذا أنكروه لم أجد بُدّاً من السيف، ولا خيرَ في خير لا يجيء إلا بالسيف. إني أَرُوض الناسَ رياضةَ الصعب، فإن يطل بي عُمُرٌ فإني أرجو أن ينفذ الله مشيئتي، وإن تغدو عليّ مَنيّةٌ فقد علم الله الذي أريد.
لقد غدا الإسلام غريباً وسط أهله بعد عقود من التجهيل والتضليل، ثم إن الأمة تعيش اليومَ حالةً غيرَ مسبوقة من الضعف والتشرذم والسقوط، فلا نحن في دعوة مكية بين كفار ولا في دولة مدنية تتمتع بالاستقلال والاستقرار، والوضع الجديد يحتاج إلى فقه جديد.
إن مسائل العلم منثورة على قوارع الطرق، والفتوى بما في الكتب ممّا يحسنه كل طالب علم، فليس عالِمُ الوقت الذي تحتاج الأمة إلى علمه هو من يفتح الكتب ليخبرنا بما فيها؛ ليس هو من يقول إن جهادَ الكفار واجبٌ على كل حال وإن الحاكميةَ أصلُ الأصول وإقامةَ دولة الخلافة أوجبُ الواجبات، إنما عالِم الوقت هو من يحسن فهم الواقع ويحسن تنزيل الحكم الشرعي عليه، من له نظر في فقه الاستطاعة وفقه المصالح والمفاسد وفقه الأولويات.
7- أخيراً فإن لنا أن نتساءل: كم نبياً من الأنبياء استطاع أن يقيم دولة التوحيد؟ بل مَن منهم جمع أتباعه وقاتل قومه لإقامتها؟ أيُلام أنبياء الله على عدم القتال من أجل دولة يكون الحكم فيها لله؟ ونبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، الذي أمضى في مكة بضع عشرة سنة يدعو الناس: هذه أخباره لم يترك أهلُ السِّيَر صغيرةً أو كبيرةً فيها إلا دوّنوها، أين تجدون فيها أنه أعلن على أهل مكة الحرب ليقيم فيها دولة الإسلام؟ وهل كانت دولة المدينة إلا فتحاً من فتوح الدعوة وأثراً من آثار البلاغ المبين؟
قال شعيب لقومه: {إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت}، وقال الله تبارك وتعالى عن رسله على الإجمال: {فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟} وقال عن نبينا الكريم على التخصيص: {فإن تولَّوا فإنما عليك البلاغ المبين}. فعلمنا أن الإصلاح والدعوة إلى الله (البلاغ المبين) هما العمودان اللذان قامت عليهما رسالات الرسل جميعاً، وهما في وسع كل إنسان، فما علينا أن نترك ما لا يسعنا إلى ما يسعنا، وأن نقتفي آثار الأنبياء الكرام؟
قد يستمر الكفر والظلم وقد نعجز عن إقامة دولة الإسلام في الأرض إلى حين، ولكننا لن نؤاخَذ بعجزنا، إنما نؤاخَذ لو تركنا الدعوة إلى الله ولو تقاعسنا عن الإصلاح ونحن قادرون عليه: {وما كان ربك ليُهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون}. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين، ولا تؤاخذنا بما لا نطيق.