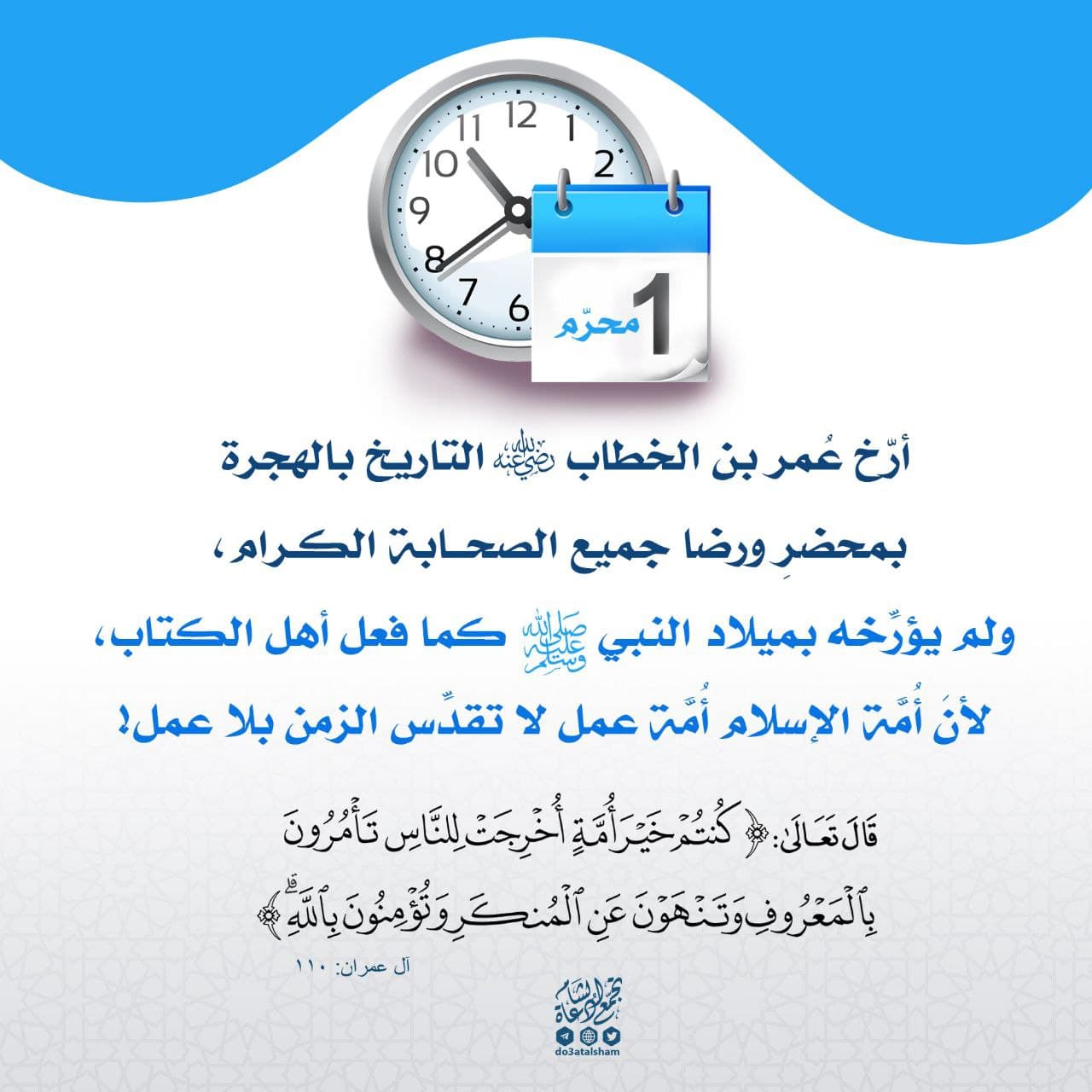من مقتل عمر إلى مقتل الحسين جريمة واحدة بأدوات متعددة

لم يكن العرب في تلك الحقبة من التاريخ يعرفون شيئاً عن الجرائم والمكائد السياسية إلا بحدود ضيقة جداً، ولم يكونوا يعرفون كذلك ما يسمى بحرب الوكالة وإن كانوا حطبها في شام الغساسنة وعراق المناذرة، حيث كانوا يتقاتلون نيابة عن القوتين العظيمتين (فارس والروم) اللتين تعلمتا بمرور الزمن كيف تتلافيان الصدام المباشر، وكيف تدبران المكائد بمختلف الأدوات والواجهات.
هناك نقطة ثالثة لا تقل خطورة عن النقطتين السابقتين وهي الوعي بما يمكن أن يسببه فراغ السلطة المفاجئ لأية دولة مهما كانت قوية ومتماسكة، وهذا ما كان يدركه الفرس والروم بحكم تجاربهم السياسية العريقة وخبرتهم في الحكم وإدارة الدول والإمبراطوريات المتباعدة الأطراف، أما العرب فلا شك أنهم كانوا يفتقرون لهذه الخبرة حتى بعد اندفاعهم مجاهدين وفاتحين في شرق الأرض وغربها.
نعم هناك حوادث جزئية حصلت في هذا السياق مبكرا، بيد أن هذه الحوادث لم ترق إلى مستوى تشكيل الخبرة والوعي اللازمين لمواجهة مثل هذه التحديات، فقد حاول بنو النضير اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم وقد حكم عليهم الرسول بالجلاء وهو لا شك علاج سياسي يتناسب مع جريمة سياسية بهذا الحجم، ولم يتعامل الرسول معها قضائيا كجريمة جنائية شخصية، وهذه سابقة في غاية الأهمية، وكان من الممكن أن تشكل مثالا يحتذى في الكثير من الحوادث التي حصلت فيما بعد خاصة تلك التي استهدفت مركز القرار في الدولة الإسلامية.
تذكر بعض الروايات أيضاً أن عمر بن الخطاب كان قد هم بقيادة معركة القادسية بنفسه بعد أن بلغه مستوى الإعداد العالي والحشد الكبير لجيش الفرس إلا أن علياً وهو وزيره الأمين قد أقنعه بالعدول لأن الفرس سيكونون أكثر استماتة لقتل (رأس العرب) وإنهاء الدولة الإسلامية، وهذا يؤكد وجود مستوى من الوعي بأهمية الحفاظ على مركز القرار خاصة في أيام الأزمات والتحديات الخارجية، لكن الذي يظهر من مجريات الأمور فيما بعد أن هذا الوعي لم يترسخ في الأمة بصورة منهجية وعملية تناسب حالة الاصطدام المباشر مع إمبراطوريتين عظيمتين كانتا تقتسمان الهيمنة على أغلب المسكون من الأرض.
ماذا يعني أن الخلفاء الراشدين لم يسلم منهم إلا الصديق –رضي الله عنهم أجمعين- بينهما قضى الثلاثة الآخرون عمر وعثمان وعلي غيلة وغدراً الواحد تلو الآخر؟! وهذه قضية أكبر من كل القضايا، ومسألة تحتاج إلى وقفة طويلة وجادة، لكن هذا لم يحصل وإلى اليوم! حيث تعامل معها المسلمون كحوادث مجزأة ومقطعة وكأنها جنايات شخصية لا أكثر، يدل على هذا تعامل المسلمين مع القتلة، ويكفي هنا الاستشهاد بوصية الخليفة الرابع بعد أن ضربه ابن ملجم على رأسه وهو متوجه لصلاة الفجر فقال: (إن بقيت فأنا ولي أمري، وإن قضيت فضربة كضربتي) ولا شك أن هذا هو أسمى حالات التجرد والبعد عن حظوظ النفس، وهو ما نفخر به بلا شك، لكن هل الذي قتل عليا كان عبدالرحمن بن ملجم؟ وهل الذي قتل عمر هو أبولؤلؤة؟ هل كانت كل هذه الجرائم المتتابعة والتي تستهدف رأس الدولة مجرد عداوات ونزاعات شخصية؟ حتى يخضع القاتل لواحد من الأحكام الثلاثة (القصاص أو الدية أو العفو)! ثم ينتهي الأمر!
لقد عاقب رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بني النضير جميعاً حينما حاول واحد منهم وهو عمرو بن جحاش قتله، وهؤلاء خلفاء الرسول وقادة الأمة من بعده واستهدافهم لا يختلف كثيراً عن استهدافه هو –عليه الصلاة والسلام- وقد كان من الممكن إجراء تحقيقات شاملة ودقيقة للتوصل إلى المجرم الحقيقي، حقيقة أني لم أجد تفسيراً مقنعاً سوى حالة التجرد والورع والتواضع التي كان يتميز بها الخلفاء الراشدون، وربما أنهم لم يشاؤوا أن يضفوا على أنفسهم اعتبارات القيادة والرمزية والموقع المحوري في الأمة وهم قريبون من لقاء الله، لكن الأمة كان عليها أن تقوم بهذا الدور، فحق الأمة أو الحق العام في هذه الجرائم حاضر وظاهر أكثر بكثير من الحق الشخصي، لكن الأمة على ما يبدو لم تكن قد تشكلت عندها ثقافة الجريمة السياسية وسبل التعامل معها، حيث كان المجتمع البدوي يميل بطبعه إلى الوضوح والصراحة والمواجهة بدل الأساليب الأخرى والتي انتعشت في الحواضر والدول المتقدمة والصراعات الخفية والعلنية على السلطة.
حقيقة أن أبا لؤلؤة وابن ملجم والشمر لا يختلفون عن عمرو بن جحاش، فلماذا حفظنا أسماءهم ونسينا الرابع؟ لأننا تعاملنا معهم بمنظور الجنايات الشخصية، بينما تعامل رسول الله مع الأخير بمنظور الجريمة السياسية التي تتعدى الشخص المنفذ للجريمة إلى الجهة التي دفعته.
إننا لا ننطلق من (عقدة المؤامرة) والتي أصبحت سلاحا ذا حدّين، وكلاهما يقتلان روح البحث العلمي والموضوعي، الأول في تبسيط الأمور وتسطيحها وتقطيعها بطريقة تفقد الباحث القدرة على الربط والتحليل والاستنباط العميق مما يوحي بتبرئة الخصوم من أية مكيدة أو مؤامرة وهذا يصادم المنطق والواقع بلا شك، والثاني في تعقيد الأمور وترسيخ ثقافة الشك والخوف من المجهول، وكأننا نعيش في عالم محكوم بالقوى الخفية من مردة الجن أو الإنس إلى الدرجة التي قد تصيبنا بالشلل وفقدان القدرة والرغبة في الدفع أو التغيير.
إن التحقيق في اغتيال ثلاثة خلفاء وبالتتابع وما تبعه من حوادث جسام ومنها مقتل الحسين -رضي الله عنه- والتي ما زالت الأمة تئن تحت وطأتها وإلى اليوم لهو أكبر من مقالة أو بحث أو أي جهد فردي مهما كان، وعلى العلماء وكل التخصصات ذات الصلة والمؤسسات المعنية أن تولي هذا الموضوع الأهمية التي يستحق، ليس من أجل محاكمة الجناة، بل لتحصين الأمة وتلافي التداعيات الخطيرة والمستمرة وعلى مختلف الصعد والاعتبارات.
لقد اختارت الأمة موقفا سلبيا ضعيفا حيث آثرت السكوت عن كل ما جرى، وانتشرت قولة من قال: ونسكت عن حرب الصحابة فالذي *** جرى بينهم كان اجتهاداً مجرداً والحق أن الذي جرى بينهم ليس بالضرورة أن يكون اجتهاداً مجرداً، فهم لم يكونوا وحدهم في الساحة، فهناك المنافقون الذين كانوا يكيدون للإسلام وأهله من أيام رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وهناك المرتدون وهذا ملف آخر لم يحظ بالدراسة الكافية، فالمرتدون هؤلاء قد انخرطوا في جيوش المسلمين بعد القضاء على قادتهم، وليس من المنطقي تبرئتهم تماما مما حصل حتى بعد إعلان توبتهم، كيف وقد انشق على علي وهو الخليفة الشرعي أكثر من عشرة آلاف مقاتل في يوم واحد؟ ثم إن هذا السكوت لم يكن ملزما للآخرين، فقاموا بتقديم قراءة جديدة لكل ذلك التاريخ تعتمد على فرضية أخطر بكثير من الجريمة نفسها، وهي فرضية تآمر الأمة نفسها على دينها وعلى قادتها وعلى أهل بيت نبيها! مما يمهد لاختطاف هذه الرموز لصناعة أمة بديلة وبهوية جديدة، ثم الانتقام من الأمة الأصيلة بعد تجريمها وتحميلها كل ما جرى
هناك جملة من المعطيات لا بد من استحضارها لتكوين التصور الأولي للمشهد السياسي والاجتماعي في تلك المرحلة كمقدمة لتحليل الفتنة الكبرى وتجميع خيوطها ومعرفة من يقف وراءها،
ومن تلك المعطيات:
1 – الصراع الإسلامي اليهودي والذي اتخذ طابعا دمويا وصل إلى حد محاولة اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم والتحالف مع المشركين في غزوة الأحزاب، وقد نتج عن هذا مقاتلتهم في بني قريظة وخيبر وإجلاؤهم عن مساكنهم في المدينة المنورة، واليهود أهل حقد وحسد، ومن غير المنطقي ألا يحاولوا تعويض خسائرهم والثأر لقتلاهم كلما سنحت فرصة، ولقد رأيناهم اليوم وبعد شتات دام ثلاثة آلاف سنة تقريبا عن فلسطين كيف تجمعوا ليعيدوا كيانهم وهيكلهم المزعوم، وإذا كان التاريخ قد حفظ لنا اسم عبدالله بن سبأ ودوره الماكر في قتل الخلفاء وإثارة الفتن ومحاولة الاختراق العقدي والفكري، فإنه لا يستبعد أن يكون معه فريق من اليهود الذين تستروا تقية بالإسلام، إلا أن الدولة الإسلامية كانت تعتمد على القضاء لمعاقبة المجرمين ولم يكن لديها جهاز استخبارات يكشف ويمنع الجرائم قبل وقوعها خاصة تلك التي تتعلق بأمن الدولة ومركز القرار فيها.
2 – ظاهرة النفاق، والتي بدأت عقب تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة، ولقد كانت ظاهرة قوية ومؤثرة في عهده عليه الصلاة والسلام إلى الحد الذي تمكنت فيه مبكرا من سحب ثلث جيش المسلمين من معركة أحد! والمنافقون لا يتورعون عن التحالف مع اليهود أو المشركين، ولا يتورعون كذلك عن إثارة الفتن بين المهاجرين والأنصار بل وحتى داخل بيت النبوة؛ حيث تولوا كبر الإفك بحق أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق -رضي الله عنهما-.
والسؤال الذي يرد بهذا الصدد؛ هذه ظاهرة تشكلت في المدينة من بعض الناس الذين تضررت مصالحهم بعد قيام الدولة الإسلامية، فكم هو حجم الذين تضررت مصالحهم في العراق والشام وحجم المنافسات الدنيوية في المال والمنصب والجاه بعد أن أصبحت كنوز كسرى بيد المسلمين؟ وإذا كان الوحي يتنزل على رسول الله ليكشف له أسماء المنافقين وأسرارهم فمن الذي يكشفهم بعد انقطاع الوحي وتوسع الرقعة الإسلامية من قرية (يثرب) إلى إمبراطورية العراق والشام ومصر؟! وإذا كانت يثرب وهي تنتمي إلى مجتمع البداوة البسيط قد أفرزت كل ذلك النفاق، فما صورة النفاق وأساليبه المتوقعة في مجتمعات الدول الكبرى التي كانت تحكم العالم في ذلك الوقت؟
3 – حركة الردة، حيث واجهت الدولة الإسلامية أكبر تحد لها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستلام أبي بكر الصديق لمقاليد الخلافة، وكان هذا التحدي بمستوى كاد يودي بالدولة الإسلامية كلها وربما بمفهومي الملة والأمة أيضا! لولا تعهد الله بحفظ هذا الدين ثم الحزم الذي أبداه الصديق في التعامل مع هذه الحركة، بيد أن الذي ينبغي التنبه له أن القضاء على حركة الردة كان بالقضاء على قادتها المتنبئين كذبا كمسيلمة وسجاح والعنسي.. إلخ لكن ليس هناك ما يطمئن أن جموع المرتدين قد خضعوا فعلا لتعاليم الإسلام وأشبعوا منه تربية وتفقها، ولا شك أن الكثير منهم قد انتدبهم أبو بكر بعد إسلامهم للحاق بجيش خالد والذي بدأ فعلا بمهمة فتح العراق.
إن هؤلاء بحاجة إلى دراسة جادة ومدى علاقتهم برؤوس الفتنة خاصة أن ظاهرة الردة السياسية ونكث العهود قد كانت السمة الأبرز في الحياة السياسية للمجتمع العراقي بعد الفتح، ففي يوم واحد ينشق أكثر من عشرة آلاف مقاتل وينقضون بيعتهم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ثم بعد ذلك ينكث الآلاف من أهل الكوفة وما حولها عهودهم ومواثيقهم للحسين بن علي -رضي الله عنهما- ومثل هذا كثير في تلك الحقبة وما بعدها.
4 – العلاقات القديمة لبعض القبائل العربية بدولتي فارس والروم، فبالإضافة إلى المناذرة والغساسنة كان هناك الكثير من العرب الذين يروحون ويغدون إلى مقر الدولتين طلبا للرزق أو الجاه، ولا ننس هنا تأثير الروم في ردة الملك العربي جبلة بن الأيهم بعد إسلامه على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه! والعلاقة التي كانت لذي الجوشن الضبابي بكسرى قبل الإسلام حتى يقال إن كسرى هو من ألبسه الجوشن (الدرع) -عون المعبود شرح سنن أبي داود ج7ص225-، وهذه العلاقات قد تكون طبيعية في عصر ما قبل الإسلام إلا أن إمكانية توظيفها فيما بعد واردة وكل بحسب مشروعه ومصلحته.
5 – دخول الكثير من الشعوب في الإسلام من عراقيين وشاميين ومصريين ومن العرب وغير العرب، وهؤلاء بالتأكيد لم تتح لهم فرصة التعمق في فهم الإسلام والنشأة على أصوله وقيمه كما كان المهاجرون والأنصار، ومن ناحية أخرى ربما كانوا يرون أنفسهم أكثر تحضرا وثقافة من الفاتحين أنفسهم، ولذلك انتعشت الفلسفات الغريبة عن الهدي النبوي، فظهر التمرد الفكري بثوب القدرية والجهمية.. إلخ كما ظهر التعالي على الصحابة وهم الفاتحون والأمراء كما في قصة أهل الكوفة مع سعد بن أبي وقاص والذين شكوه إلى عمر بن الخطاب لأنه لا يحسن الصلاة! حتى جاء في البخاري أن عمر قال لسعد: (يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي)! صحيح البخاري رقم 755. ثم تطور الأمر على يد الخوارج باتهام علي بن أبي طالب بالكفر وأنه لا يفهم عقيدة التوحيد الصحيحة! إن الخطورة في مثل هذا التعالي على صحابة رسول الله وإن اتخذ طابعا علميا في بداية الأمر لكنه لا شك قد جرّأ الغوغاء على النيل منهم بل وقتلهم كما حصل في مقتل طلحة والزبير وعلي والحسين، وهنا لا نستبعد الكيد السياسي في هذا التعالي أو الغرور العلمي، فمثلا في الوقت الذي كانت جموع الفرس تتجمع في نهاوند للانقضاض على جيش سعد كان أهل الكوفة يطلبون من عمر أن يعزل سعدا لأنه لا يحسن الصلاة! هذا التوقيت لا يمكن أن يكون عابرا ولا غبيا!
6 – وجود حالة من المنافسة داخل البيت القرشي، وهي منافسة طبيعية لكنها قد توظف توظيفا آخر، فأبو سفيان كان زعيم قريش خاصة بعد موت أبي طالب وهجرة بني هاشم مع رسول الله إلى المدينة، وإذا كان الإسلام قد ألزم بني أمية ببيعة الرسول والخضوع لإمامته، فإنه ليس هناك من نص يلزمهم بالخضوع لبقية بني هاشم بعد رسول الله، كما أن أولاد العباس يرون أنهم الأقرب إلى رسول الله والأحق بإرثه حتى من علي وأولاده، فالعم مقدم في الإرث على ابن العم، وقد أنتج هذا نزاعا داخليا آخر بين بني هاشم (العباسيين والعلويين) حتى حسم الأمر للعباسيين فيما بعد.
صحيح أن الجو العام في الأمة لم يتأثر بهذه الثغرات والتحديات، وكانت الفتوحات الإسلامية تتوالى في المشرق والمغرب، وأخبار النصر المتلاحقة تنعش النفوس وتجعلها أقدر على امتصاص الأزمات وحل المشكلات، إلا أن هذا لم يكن ليمنع حالات الالتفاف واستغلال هذه الثغرات من قبل الأطراف المهزومة أمام القوة العسكرية للمسلمين.
كل واحد من تلك المعطيات ينهض بنفسه ليكون سببا منطقيا لارتكاب الجرائم السياسية في تلك المرحلة الحرجة من تاريخ الأمة، وقد حصل هذا مبكرا حينما حاول بنو النضير اغتيال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا يبعد عنه محاولات المنافقين للطعن في بيت النبوة وإثارة الفتنة بين المهاجرين والأنصار، ثم إعلان الردة المسلحة في اليوم الأول من خلافة أبي بكر والذي كاد يودي بالدولة والأمة.
أما بعد الاصطدام المسلح مع جيش كسرى فإن خارطة الصراع الكلية قد تغيرت، فنحن أمام معادلة معكوسة أو مقلوبة، فهناك دولة كبرى قد انهار جيشها بيد أنها ما زالت تملك كل أدوات الدولة العميقة في مقابل دولة ناهضة بقوة عسكرية متقدمة لكن مع ضعف في أجهزتها الأمنية وخبراتها الإدارية والسياسية.
وفق هذه المعادلة الجديدة فإنه من الطبيعي أن تتجه الأمور وجهة أخرى تعتمد الحرب الخفية الباطنية والمكائد السياسية، وهذا ما تؤكده كل الوقائع التي حدثت من مقتل عمر الفاروق وإلى مقتل الحسين -رضي الله عنهما- ولعلنا من خلال هذه العينات نستطيع أن نسلط الضوء على هذه المساحة الغامضة والخافتة:
في مقتل عمر الفاروق -رضي الله عنه- تتردد ثلاثة أسماء: الهرمزان، وجفينة، وأبو لؤلؤة، قال عبدالرحمن بن أبي بكر غداة طعن عمر: «مررت على أبي لؤلؤة ومعه جفينة والهرمزان وهم نجيٌّ، فلما دهمتهم ثاروا وسقط منهم خنجر له رأسان، نصابه في وسطه، فانظروا بأي شيء قتل عمر، فجاؤوا بالخنجر الذي ضرب به أبو لؤلؤة فإذا هو على الصفة التي وصفها به» الطبري 4/19. أما أبو لؤلؤة فهو عبد مجوسي كان يعمل حدادا ونجارا ونقاشا وقد استغل حاجة الناس في المدينة لهذه المهن فاستثني للاستقرار فيها بخلاف غيره من الغرباء، وقد توعد الخليفة الفاروق قبل أيام من قتله ثم نفذ وعيده، وأما جفينة فهو من نصارى عرب الحيرة المعروفين بولائهم لكسرى وقد قدّم نفسه لسعد بن أبي وقاص كمعلّم للقراءة والكتابة فبعث به سعد إلى المدينة واستقر فيها مع أبي لؤلؤة! وأما الهرمزان فقد كان حاكم الأحواز أيام كسرى وكان قائدا عسكريا كبيرا، ولم يسجل التاريخ الفارسي رجلا أكثر عنادا ودهاء ووفاء لفارس من الهرمزان، فقد قاتل المسلمين في أكثر من وقعة وحتى بعد انهيار جيش كسرى في القادسية، وقد عاهد المسلمين أكثر من مرة ثم غدر بهم، وفي حواره مع الخليفة عمر بعد أسره أبدى دهاء لا مثيل له ومعرفة بعادات العرب وطبائعهم، وقد أعلن إسلامه لعمر فأبقاه في المدينة.
إنه لمن المؤسف في تاريخنا أن تجد نقاشا طويلا حول الأحكام الفقهية والقضائية المتعلقة بقيام عبيد الله بن عمر بقتل الهرمزان، وهل كان عليه القصاص أو لا؟ وهل يجوز لولي الأمر عثمان بن عفان أن يفتديه بالدية؟ وما إلى ذلك.
ثم لا نجد أي جهد تحليلي لمعرفة الدوافع الكامنة وراء هذه الجريمة الكبيرة! في مقتل الحسين بن علي -رضي الله عنهما- تظهر مسألة جديدة تكاد تكون المحرك الأول لهذه الفتنة وهذه الفجيعة، ولم يقف عندها علماؤنا ومفكرونا بالقدر الذي تستحق، ألا وهي مسألة (الرسائل)؛ حيث يجمع المؤرخون على أن الحسين حينما غادر العراق واستقر في الحجاز بعد مقتل أبيه وتنازُل أخيه الحسن بدأت تصله رسائل كثيرة من أهل العراق لا حصر لها، حتى أوصلها بعضهم إلى خمسمئة رسالة يؤكدون له فيها عهد عشرات الآلاف له بالسمع والطاعة وأنهم ليس لهم إمام وقد رفضوا بيعة يزيد، وقد ظهرت أسماء كثيرة كانت مهمتهم نقل هذه الرسائل من أبرزهم عبدالله بن مسمع الهمداني وهو شخص غير معروف إلا من خلال هذه المهمة! إن الذي يستدعي الانتباه هنا هو خوف الحسن بن علي على أخيه الحسين من هذه الرسائل! وذلك لا شك بحكم خبرته بأهل العراق، حيث روى الطبري أنه كان يلقي بالكتب التي ترده في مخضب ولا يفتحها فقيل له في هذا فقال: «هذه كتب أهل العراق من قوم لا يرجعون إلى حق ولا يقصرون عن باطل، أما فإني لست أخشاهم على نفسي ولكني أخشاهم على ذلك وأشار إلى الحسين» صحيح الطبري 4/122.
وقد كان موقف علماء الصحابة الكبار كعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس وعبدالله بن الزبير لا يختلف عن موقف الحسن، فقد قال ابن الزبير للحسين يوم خروجه: أين تذهب؟ إلى قوم قتلوا أباك وأخرجوا أخاك، وقال ابن عباس لحظة الوداع: أستودعك الله من مقتول. صحيح الطبري 4/118.
لقد أدرك الحسين صوابية رأي هؤلاء الصحابة بعد أن واجه أهل الكوفة في الطف فأنكروا رسائلهم، ولحد اليوم لا توجد دراسة علمية رصينة حول هذه الرسائل، وهي ربما لا تختلف كثيرا من حيث المغزى والنتيجة عن الكتاب الذي كان عليه ختم عثمان بن عفان والذي أشعل الفتنة في عهده.
وقد أكد أولاد الحسين هذه الحقيقة فقد قالت سكينة بنت الحسين: «يا أهل الكوفة يا أهل الغدر والنفاق لقد يتمتموني صغيرة وأيمتموني كبيرة -تشير إلى قتلهم لزوجها مصعب بن الزبير بعد فاجعة الحسين- فقتلتم أبي وجدي وعمي وأخي وزوجي، ألا بعدا لكم ولمكركم» تاريخ ابن كثير 8/230، ويقول زين العابدين علي بن الحسين: «هيهات أيها الغدرة المكرة.. أتريدون أن تأتوا إلي كما أتيتم إلى آبائي من قبل» الاحتجاج للطبرسي من علماء الشيعة 2/32.
وجاء في رجال الكشي عن جعفر الصادق: «لو قام قائمنا لبدأ بكذابي شيعتنا فقتلهم.. وإن ممن ينتحل هذا الأمر لمن هو شر من اليهود والنصارى والذين أشركوا» ص253.
وقبل هؤلاء جميعا كان عمهم الحسن يقول: «يزعم هؤلاء أنهم لي شيعة، ابتغوا قتلي وانتهبوا ثقلي وأخذوا مالي، والله لأن آخذ من معاوية عهدا أحقن به دمي وأؤمن في أهلي خير من أن يقتلوني فيضيعوا أهل بيتي وأهلي، ولو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه» الاحتجاج 2/10، وسبحان الله كأنها نبوءة في مصير الحسين الذي لاقاه على أيديهم.
إن هذه المقولات تدل بوضوح أن هناك شيئا ما أكبر بكثير من موضوع الخطأ الفردي أو التقصير، وهو ما دفع الحسن للصلح مع معاوية بالفعل، وما دفع الحسين أيضا حيث عرض على أهل الكوفة أن يرسلوه إلى يزيد أو يسمحوا له بالجهاد على ثغر من ثغور الإسلام أو يرجع إلى الحجاز، لكن الشمر أقنع ابن زياد برفض كل هذه المطالب.
إن هذه الفتنة لم تقف عند هذا الحد، ففي كل مواجهة حادة تظهر بلبوس جديد لتطعن الأمة في ظهرها أو في خاصرتها، لقد وقف نصير الدين الطوسي والوزير ابن العلقمي مع هولاكو في تدميره لبغداد، وتحالف الصفويون مع الصليبيين لإجهاض الفتوحات الإسلامية في أوروبا أيام العثمانيين، يقول علي شريعتي: «من القضايا الواضحة وجود نحو ارتباط بين الصفوية والمسيحية حيث تضامن الاثنان لمواجهة الإمبراطورية الإسلامية» التشيع العلوي ص206.
إن ما يحصل اليوم لا يمكن أن ينفك عن كل ذلك التاريخ بعد أن أصبح هوية وثقافة ومحركا محوريا للكثير من السياسات والمشاريع التي نواجهها على مختلف الصعد