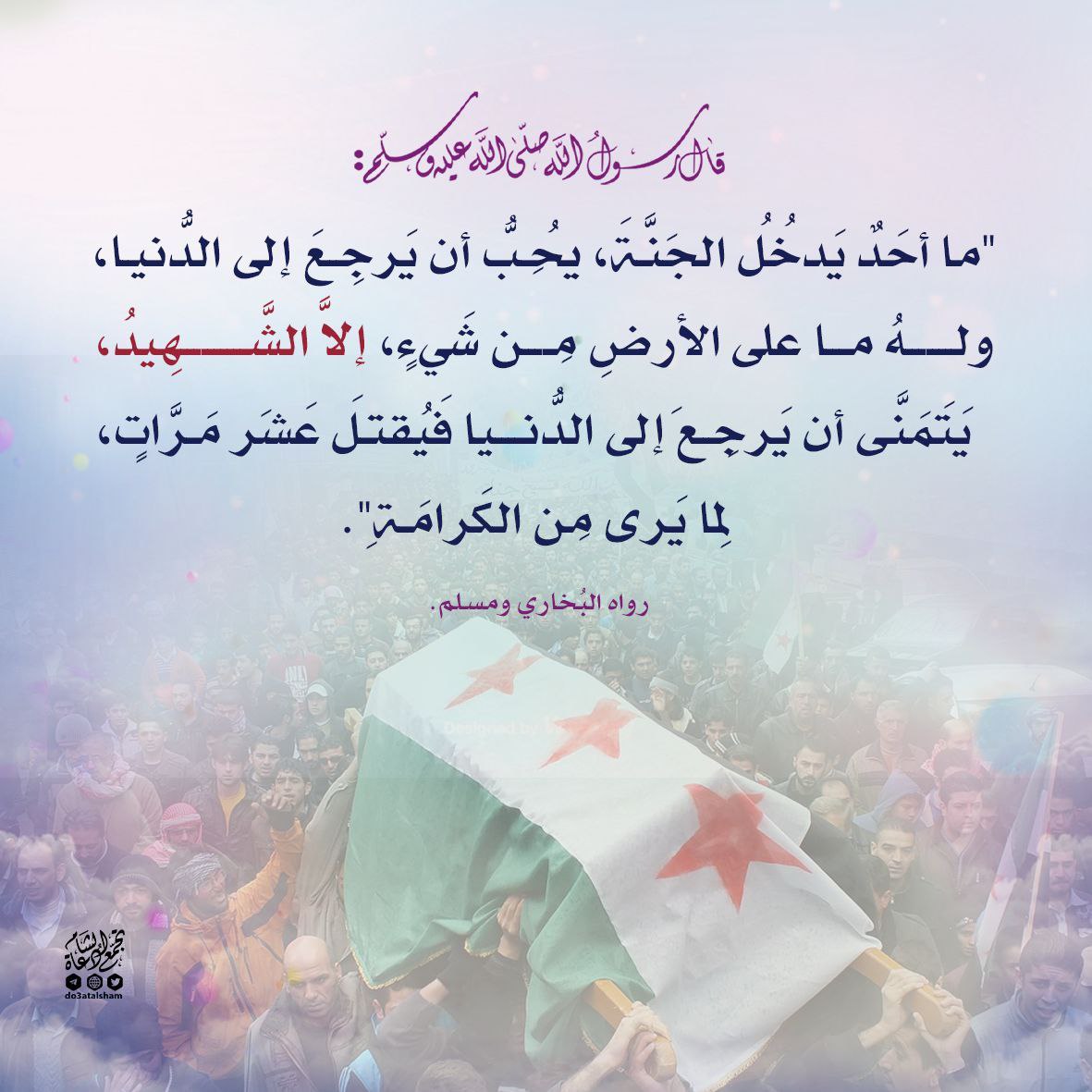بثيابه الصفيقة وسيفه وتُرْسه وفرسه القصيرة، يدخل ذلك المسلم العربي على قائد الفرس الجالس على سرير الذهب، لا يُبالي بأُبَّهةِ مُلكه ولا بمظاهر سطوته، بل جعل يتوكأ على رُمحه فخَرَق النمارق المبسوطة وكأنه يخرق بها هيبتهم، فيسأله الفارسي: ما جاء بكم؟
فأجابه: “الله ابْتَعَثْنَا لِنُخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ، وَمِنْ ضيق الدنيا إلى سِعَتِهَا، وَمِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ”.
ما أكثر ما سقط من ذاكرة التاريخ، فإنه لا يحتفظ إلا بالكلمات الفارِقة ذات المعاني السامية، ومما حفظه لنا التاريخ تلك المقولة السابقة التي أجراها الله على لسان الصحابي الجليل ربعي بن عامر، وما ذاك إلا لأنها اختصرت رسالة الإسلام الخالدة وأوضحت جوانب عظمتها، وعلى أعتابها وجب الوقوف تأمُّلًا وتدبُّرًا.
“الله ابتعثنا”.. فرسالتنا ربانية المصدر، تصل الأرض بالسماء، جاءتنا من الله، وتُحرّكنا إلى الله، وحملنا على عاتقنا هداية الضالين، كتابنا محفوظ، وسنة نبينا مُسندة، ومنهجنا واضح، ورسالتنا عالمية، تصل السابقين باللاحقين، والأولين بالآخرين، وأهل المشارق بالمغارب.
“لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله”، فإنما هي الرسالة التي تُعلي من شأن ذلك المخلوق الذي كرّمه ربه وحمله في البر والبحر وفضّله على كثير ممن خلق تفضيلا، تصون هذه الخلقة المُكرّمة عن دنس الشرك وعبادة كل مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا.
جاءت شريعتنا لتُقِيم ظهور البشر التي طالما انحنت ركوعا لغير خالقها، وأرهقتْها رِبْقة تأْلِيه الملوك والطواغيت، جاءت ليستقيم أمر الإنسان مع فطرته الشاهدة على وحدانية الله، وتُوحِّد وِجْهَته إلى إلهٍ واحد لا يُعبد بحقٍ سواه، وهي على ذلك الطريق تُحرّك الوجدان للوصول الإنسيابي إلى إفراده تعالى بالعبودية {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ } [الزمر: 29]، أو هي كصيحة يوسف في غيابت السجن {أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ } [يوسف: 39].
لما أشرقت شمسها رُدّت كرامة الإنسانية، فكتابها قد نحّى جميع المعايير البشرية الظالمة التي أُهدر فيها تقييم الإنسان، فقرّر المعيار الأوحد بعد أن ذكّر عباده بأصل النشأة الأولى التي تساوى فيها الجميع {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ } [الحجرات: 13].
ونبيها يفترش الغبراء مع العبيد، ويقول لرجل ارتعد مهابةً له: (هَوِّنْ عَلَيْكَ، فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكٍ، إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ).
“ومن ضيق الدنيا إلى سعتها”، ذلك الضيق الذي كان مرَدُّه إلى الظلم الاجتماعي وحصْر الثروات في يد قلة تعبث بخيرات البلاد، وتُسخّر العباد لمآربها ومصالحها.
ذلك الضيق الذي كان مردُّه إلى هيمنة التصورات الباطلة عن الكون والحياة، فباتت الأنفس غارقة في الحيرة والقلق، أسيرة لتوارد الأفكار والتردد بينها.
ذلك الضيق الذي كان مرده إلى سيطرة المفاهيم المغلوطة حول طبيعة العلاقة بين الدنيا والآخرة لدى من يؤمن بها، فمن ثم غرق الناس قبل الإسلام في مادية بحتة أو رهبانية وعزوف عن الحياة.
ذلك الضيق الذي كان مرده إنكار قطاعات واسعة من البشرية للمعاد، فباتت خاضعة لواقعها المرير دون وجود تطلعات أخرى لحياة أبدية سعيدة على مبدأ الثواب والعقاب، هي في حد ذاتها سلوان للبائسين.
فجاء الإسلام لكي يضع حدًا لظلم الإنسان لأخيه الإنسان، ووازن بين حق التملك وكفالة العدالة الاجتماعية، وافترض على العباد زكاة تُؤخذ من أغنيائهم لترد إلى فقرائهم، ووضع منظومة اقتصادية يصلح بها المعاش.
جاء ليضع تصورات واضحة عن الكون والحياة وعلاقة الخالق بالمخلوق وعالم الغيب، فيعلم الإنسان في ظل هذه العقيدة المنشأ والمصير، وبينهما الوجهة والمسار، فكانت مصدر سعادته كما قال الشاعر:
إنَّ السعادةَ أن تعيشَ لفكرةِ الحقِّ التليد
لعقيدةٍ كبرى، تحلُّ قضيةَ الكونِ العتيد
وتجيبُ عمَّا يسألُ الحيرانُ في وعيٍ رشيد
فتشيعُ في النفسِ اليقينِ وتطردُ الشكَ العنيد
وتردُّ للنهجِ المسددِ كلَّ ذي عقلٍ شريد
هذي العقيدة للسعيدِ هي الأساسُ هي العمود
ثم هي مع ذلك تصنع للإنسان نظرة متوازنة تجاه طبيعة العلاقة بين الدنيا والآخرة، فالأولى مزرعة والآخرة حصاد، الحياة الدنيا جسر ومعبرٌ إلى الآخرة، وهما طريق واحد أوله في الدنيا وآخره يوم المعاد، فكان شعار المؤمنين فيها {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً } [البقرة: 201]، فاتسعت لهم الدنيا من بعد ضيق.
ثم تراها من بعد ذلك تُبشر المؤمن بأن سجنه في الدنيا لن يدوم، وعما قريب سوف يصل إلى السؤدد وحياة الخلد ومُلك لا يبلى، فإن هي إلا غمسة واحدة في الجنة تُنسيه كل مآسي الدنيا، فمن ثم اتسعت له الدنيا عندما خالطت بشاشة الإيمان قلبه، عبَّر أحد هؤلاء المنعمين عن نعيمه، فقال بعدما أكل كسرة خبزٍ يابس، واغترف غرفة من نهر جارٍ: “لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، لجالدونا عليه بالسيوف”.
“ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام”، فكان الناس تائهين بين شرائع سماوية قد حرّفها أهلها فتبدل فيها ميزان العدل والقسط الذي أقامه الله للناس، وبين مناهج وضعتْها أيدي البشر، واحتوت على ما ينفع واضعيها وطبقات الحكام وأعوانهم.
كانت المرأة هملًا ومتاعًا يُورّث، وحار بعضهم في أمر خلقتها هل هي إنسان له روح، وبعضهم اعتبرها مصدر شرور العالم، وبعضهم حرّم عليها الحياة بعد وفاة زوجها، والبعض الآخر كان يدعي الحق في أن يزهق روح زوجته كيفما يشاء.
وأما العبيد فلا حق لهم إلا في لقيمات تضمن لهم الحياة فقط ليخدموا أسيادهم، يُدفع بهم في ساحات الحرب أمام الأسنة والرماح، ويُلقى بالعَجَزة والضعفاء منهم للوحوش، مدرجات الموت الرومانية كانت أكبر دليل على ظلم الإنسان، عندما كانت السعادة ترتسم على الوجوه لمرأى الوحوش وهي تأكل لحوم وعظام أصحاب الأحكام في الساحة، أو لمشاهد القتال حتى الموت في مسابقات بين العبيد، لإبهاج الأسياد وإضحاكهم.
جاء الإسلام بميزان القسط والعدل {وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (7) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (8) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ} [الرحمن: 7 – 9]، وأمر الناس بالعدل حتى مع أعدائهم {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [المائدة: 8].
في ظل الإسلام سادت المرأة وحصلت على حريتها واستردت كرامتها المُهدرة، وجفف الإسلام منابع الرق بالمُكاتبة والترغيب في العتق وتضَمُّن معظم الكفارات عتق الرقاب حتى كفارة اليمين، ولم يترك سوى منبعا واحدا وهو الاسترقاق في الحرب، فليس هناك معنى لأن تُطلق أسرى عدوك فتشجعه عليك، غير أنهم يجدون المعاملة اللائقة بكرامة الإنسان لدى المسلمين، تلك المعاملة التي تُعرفهم بالإسلام وتقربهم من أهله.
تلك الرسالة التي اختصر لنا معالمها ربعي بن عامر، هي التي سار بها أجدادنا، وشيدوا بها حضارة أذهلت العالم بأسره، وعلى أضوائها التي تبعثرت يعيش الغرب، وعلى نتاجها بنى علومه وازدهاره باعتراف المُنصفين منهم أمثال جوستاف لوبون وسيغريد هونكه وغيرهما.
فإذا كانت رسالة الإسلام بهذه العظمة وبهذا السمو، فلماذا تخلف المسلمون وأصبحوا في ذيل الأمم؟
ذلكم هو موضوع رسالتنا القادمة، وللحديث بقية بإذن الله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.